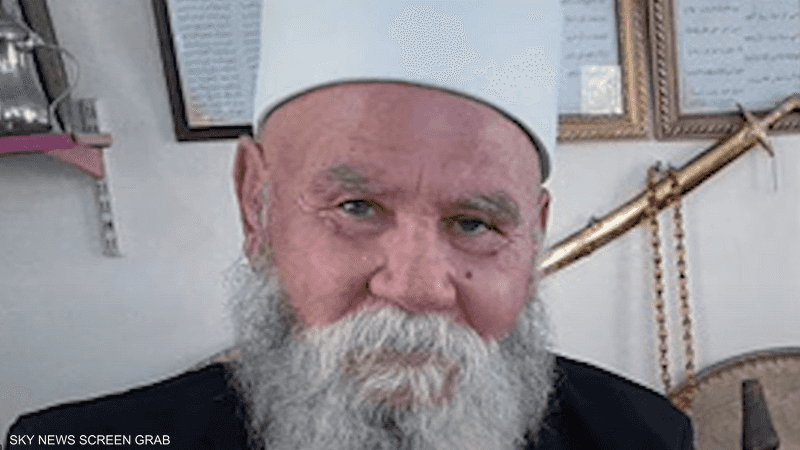بعد اشتباكات عنيفة.. المجموعات الدرزية تستعيد السيطرة على السويداء
من ميشال من ميشال عون إلى وريثهإلى وريثه
ليس تفصيلاً أن تدخل في بازار إسرائيلي-أميركي يتّصل بترسيم الحدود، ولو تخطّى هذا البازار وتخطّيت معه كلّ حدود، وتستدرج في الوقت نفسه بشّار الأسد إلى قلب معادلة رئاسة الجمهورية والموارنة بعد 18 عاماً على خروجه منها.
ad
وليس بسيطاً أن تُزامن بين التسليم بأنّ السيّد حسن نصرالله هو مستودع ضماناتك للدور والمستقبل، وبين أن تعقد جلساتٍ لدراسة آخر نسخة من مشروع لبنان فدرالية إثنية.
ليس الكلام هنا عن جبران باسيل، بل عن مستقبل بلد ووجود وطن.
خطُرٌ متخيلٌ
تبدأ القصّة منذ زمن بعيد. منذ قيام هذا اللبنان وقيام الصراعات فيه وعليه.
طوال قرن كامل ربّما، كانت عوامل الأزمات كثيرة متشعّبة: أطماع خارجٍ متعدّد، نشوء كيان غاصب محاذٍ معادٍ، عجز داخلي عن مواءمة تركيبة الدولة مع طبيعة المجتمع، سيطرة استابليشمانت إقطاعيّ ريفيّ بذهنيّة القرون الوسطى على جماعات سكيزوفرينية الوجدان التي تعيش، في اللحظة نفسها، بين هوسها بعصر الأونلاين، وبين انتمائها إلى عصر الآلهة البدائية وطلاسم القبيلة وأضحيات الحروب والشرور.
وقد لا ينتهي تعداد أسباب الصراعات الدورية الموسمية.
لكن طوال تلك الحروب، كان واضحاً جليّاً أنّ غالبية اللبنانيين، وخصوصاً أكثريّة واضحة من المسيحيين، زعاماتٍ وأقناناً، توزّعت بين مدرستين اثنتين في فهم المسائل السياسية وسلوك القضايا الوطنية.
مدرسة أولى تقول بأنّ جوهر أزماتنا هو داخلي، وأنّ "التناقض الأساسي" لقضيّتنا هو مع القبيلة اللبنانية المقابلة. أتباع هذه المدرسة، من المسيحيين مثلاً، قالوا بأولوية خطر المسلمين الداخلي على أيّ أمر آخر. خطرهم المتخيَّل على "شيء ما" تبدّلت أسماؤه كثيراً. تحت لافتة نضال لبناني هنا، من أجل كيان وميثاقية وتوافقية وسيادة واستقلال، إلى ضمانات وامتيازات، إلى تعدّدية وخصوصية وتنوّع...
فيما أقرانهم من المسلمين مطابقون، مع تسميات مقابلة مختلفة في الشكل، مكمّلة في الأساس. كلام عن نضال وطني هناك، من أجل شراكة وعروبة وقضية مركزية وإصلاحات وعدالات...
وهي كلّها في جوهرها تعبيرات عن خوف الزعامات على لعبة السلطة.
الإستقواء بالخارج على الداخل
لم يتردّد أصحاب هذه المدرسة ولم يتأخّروا في اختراع حلّ بسيط مبسّط: لا بدّ من الاستقواء بعامل خارجي على عدوّنا الداخلي. أيّ خارج متاح نستدرجه إلى حربنا الصغيرة. نستخدمه فيها. ننتصر بقوّته على الآخر-الجهنّم ونحكمه بفضل عضلاته. نوظّفه عندنا جيشاً لجماعتنا التي لا جيش لها. ثمّ نُخرجه من معادلاتنا متى استقرّت السلطة لنا... وحتى لو لم نتمكّن من إخراجه لحظة نريد، يظلّ الثمن الذي ندفعه لهذا الخارج المستقوى به، لبلوغنا السلطة وبقائنا فيها، أقلّ بكثير من أيّ ثمن ندفعه في غيابه، نتيجة وصول غريمنا البلديّ إلى سلطة البلد وتحكّمه فيها وفينا.
وكانت مدرسة ثانية معاكسة. هي مدرسة المؤمنين بأنّه صحيح أنّ ثمّة اختلافات لبنانية داخلية، لكنّها أوّلاً قابلة دوماً للتسوية ضمن حدود الوطن وضوابط الدولة، وثانياً أقلّ خطراً على وجود الجماعات كلّها، وخصوصاً على وجود وطن مستقلّ ودولة سيّدة، من أيّ دور خارجي. ولذلك، ثالثاً، تظلّ القاعدة اللبنانية الأسلم للبقاء هي في الاقتناع بأنّ أيّ ثمن ندفعه لشريكنا في الوطن، لقاء أيّ تسوية وطنية، يظلّ أقلّ بكثير من أيّ ثمن يمكن أن يدفعه أيّ منّا لأيّ طرف خارجي نستدرجه إلى ساحاتنا وصراعنا، حتى لو أدّى استقواؤنا هذا إلى إعطائنا أرجحية سلطوية، فهو عابر زائل، وحتى لو تحوّل مبدأ التسوية الوطنية إلى نوع من العمل اليومي والمسلسل التسوويّ الذي لا ينتهي، يظلّ السبيل الوحيد لحياتنا معاً، فيما الاستقواء بالخارج يظلّ الطريق المؤكّد لموتنا متفرّقين.
ad
ولم يتأخّر التاريخ وأحداثه في تأكيد صوابيّة المدرسة الثانية.
وبمعزل عن التفاصيل المكوِّنة لكلّ حدث في لحظته وسياقاته، يظلّ الثابت أنّ منطق المذهب الأوّل هو من جاء إلى لبنان بمتدخّل دخيل في شؤونه الداخلية، بدءاً بأيزنهاور وعبد الناصر، وأبي عمّار وأرييل شارون، وحافظ الأسد وصدّام حسين، وصولاً إلى كلّ مشتقّاتهما المحدثة في كلّ عصر وعهد... وفي كلّ مرّة، كان اللبنانيون يدفعون الثمن. وكان أصحاب الاستدراج والاستقواء، من بين أوائل الساقطين دمويّاً في لعبة تذاكيهم وتوهّمهم أنّ العالم كلّه يشتغل عندهم، ومجّاناً بلا أيّ مقابل.
على مدى تاريخ هذا البلد المعاصر، كانت واضحة جدّاً تجلّيات المدرسة الأخرى: بشارة الخوري ورياض الصلح جسّدا أوّل ظاهرة لمفهوم الكيان. بعدهما شكّل نموذج فؤاد شهاب قمّة في هذا التوازن، مع أوّل ترجمة فعليّة لمعادلة التكامل المطلوب بين تسوية داخلية لبنانية على أساس بناء الدولة الحديثة، وتسوية عربية على أساس السيادة والانتماء الحضاري والسياسي معاً، حتى بدت خيمة الحدود تلك سنة 1959 وكأنّها قبّة فولاذية لأوّل ترسيم كياني لوطن قابل للحياة. حتّى لحظة 2005، التي قدّمت للتاريخ أمثولة عن كيفيّة انتصار الوطنية الجامعة على أصحاب حسابات الوصايات.
عون وصحراؤه الطويلة
يوم أطلّ ميشال عون على الشأن العامّ الوطني سنة 1988، بدا مصرّاً على الانتماء إلى هذه المدرسة بالذات. رفض الميليشيات والدويلات والسلاح. وأعلن تبرّؤه من أيّ كلام طائفي أو مذهبي. لا بل ذهب في رفضه منطق الاستقواء بالخارج إلى حدّ استعداء هذا الخارج. وهو ما شكّل أحد أسباب سقوطه يومذاك.
قَبِل أن يعبر صحراءه الطويلة، من دون أيّ تبديل في هذه القناعة. منذ نُقل إليه تأييد سوريّ لرئاسته الجمهورية سنة 1989، فأجاب ولِمَن تكون الجمهورية؟ إلى لحظة لقائه إليوت أبرامز خريف 2005، حين طرح عليه سؤالاً استطلاعيّاً عن مصير الاستحقاق الرئاسي، فأجاب بأنّ هذه مسألة لبنانية يبحثها في بيروت لا في واشنطن.
لم يلفظ ميشال عون مرّة أنّ سلاحاً ما هو ضمانة دوره ومستقبله. ولم يستذكر لحظة أنّ بشار الأسد طمأنه إلى مارونية الرئاسة. ولم يعتقد يوماً بأنّ زمناً سيأتي، حيث يُحكى باسمه ومن رصيده وإرثه مثل هذا الكلام.
في تاريخ السياسة يُقال إنّ هناك نوعين من الشاغلين فيها: الذين يريدون أن يحقّقوا شيئاً ما، والذين يريدون أن يكونوا شيئاً ما وحسب، ولو لم يحقّقوا شيئاً.
في لبنان، ثمّة معادلة مقابلة: السياسيون الذين ينتمون إلى مدرسة التسويات الوطنية يريدون وطناً، والذين ينتمون إلى مدرسة الاستقواء بأيّ خارج أو داخل- خارج يريدون سلطة، ولو على حساب كلّ الوطن.
طبيعي جداً أن يكون على كلّ إنسان واجب تعلُّم الدروس من كلّ يوم. لكن من غير الطبيعي أن يكون على وريث ميشال عون أن يتعلّم أبسط دروس مورِّثه البديهية في السياسة والرئاسة.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|