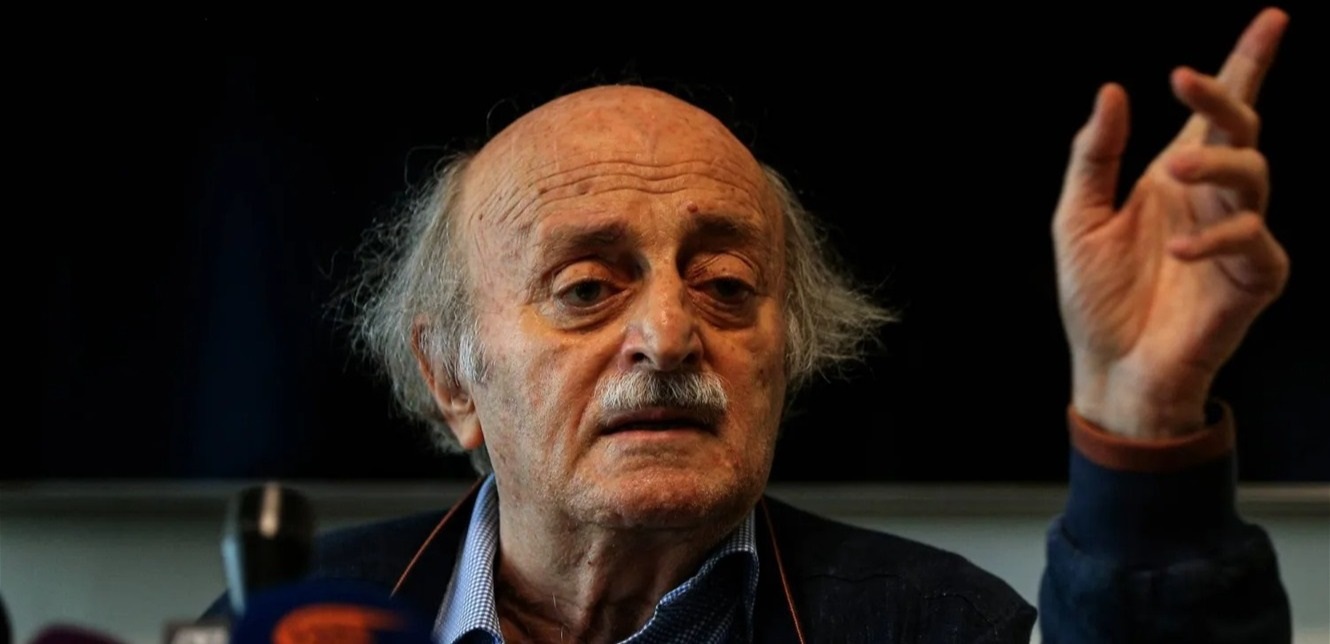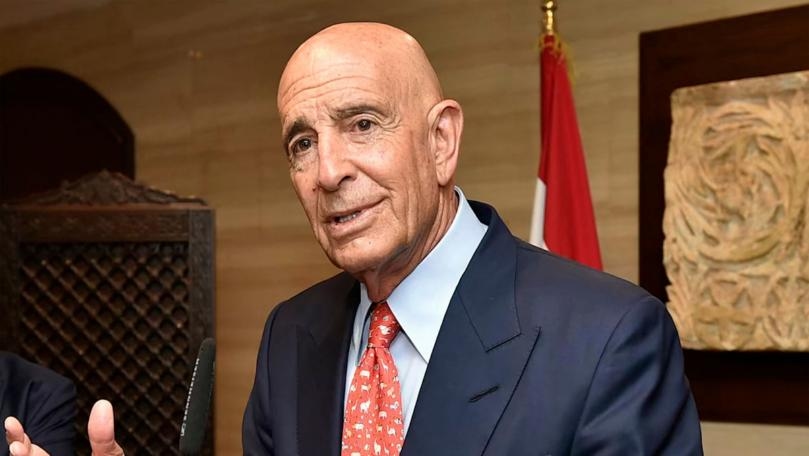السّرّيّة المصرفيّة اللبنانية: صناعة ثقة أم حماية فساد؟
حين أقرّ لبنان قانون السريّة المصرفية في 3 أيلول من عام 1956، كان يسعى إلى ترسيخ مكانة المركز الماليّ الإقليمي الذي يمثّله، في ظلّ أوضاع سياسية متوتّرة في محيطه العربي، ومنافسة شرسة من العواصم المجاورة. فما هي هذه السرّية؟ وما هي التعديلات التي طرأت عليها؟ وهل ما كان يصحّ في خمسينيّات القرن الماضي لا يزال يصحّ اليوم؟
أُريد للسرّية المصرفية أن تكون حجر الزاوية في نظام اقتصادي ليبرالي يحمي خصوصيّة أصحاب الأموال ويشجّع على استقطاب الرساميل الأجنبية، لا سيما من دول تعاني من التأميم والملاحقة. وقد نجح لبنان آنذاك في استثمار هذا القانون ضمن سياسة “الحرّية الاقتصادية”، فاستفاد من تقلّبات المنطقة وغياب الشفافية فيها ليجذب أموالاً وودائع ضخمة، ويؤسّس لقطاع مصرفي كان يُضرب به المثل في متانته وانفتاحه.
لكنّ هذه الروحيّة التي أُسّس عليها القانون، لم تتطوّر مع الزمن، وبقيت السرّية المصرفية سارية من دون قيود، حتّى بعدما بدأت المعايير الدولية تتغيّر، وضغوط الامتثال والشفافية تتصاعد. وما كان يُعدّ في الخمسينيّات أداة لحماية الثقة، تحوّل في العقود الأخيرة إلى أداة لحماية الفساد، والتستّر على التهرّب الضريبي، وإضعاف القضاء، وعرقلة التحقيقات في الجرائم المالية.
بعد الانهيار الماليّ الذي بدأ عام 2019، لم يعد من الممكن الدفاع عن استمرار هذه الحصانة المصرفية الشاملة، خصوصاً مع إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل الماليّ (FATF)، وضياع حقوق مئات آلاف المودعين، واتّهامات متصاعدة بتبييض الأموال وتهريبها خارج النظام المصرفي.
نقلة نوعيّة أم التفاف ناعم؟
لم تأتِ التعديلات على قانون السرّية المصرفية وقانون النقد والتسليف استجابة تلقائيّة لرغبة إصلاحية محلّية، بل تحت وطأة ضغوط دولية، ومن أجل محاولة تفادي العزلة الماليّة وتحقيق حدّ أدنى من الشفافية المطلوبة للعودة إلى النظام الماليّ العالمي. لكنّ السؤال الكبير لا يزال قائماً: هل هذه التعديلات كافية؟ وهل تشكّل نقلة نوعيّة نحو بناء نظام ماليّ خاضع للمساءلة؟ أم محاولة التفاف ناعمة على جوهر الإصلاح الحقيقي.
في سياق التزامات لبنان بالإصلاح الماليّ، وتحت ضغط متزايد من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، أُقرّت تعديلات على بعض الموادّ الأساسية في قانون السرّية المصرفية الصادر عام 1956، وقانون النقد والتسليف. وعلى الرغم من الترحيب بهذه التعديلات كخطوة أولى نحو الشفافية والمساءلة، سرعان ما احتدم الجدل في فعّاليّتها، خصوصاً لجهة سريانها الزمنيّ وأثرها الرجعيّ.
– أوّلاً: المادّة 150 من قانون النقد والتسليف.. من الحصانة إلى النفاذ المحدود
شكّل تعديل المادّة 150، بموجب القانون رقم 306/2022، نقطة تحوّل مهمّة. فقد أزال الامتياز المطلق الذي كانت تتمتّع به المصارف في إطار السرّية المصرفية، وفتح الباب أمام مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والجهات المفوّضة من قبلهما للاطّلاع على الحسابات المصرفية من دون قيود.
الأبرز في هذا التعديل أنّه نصّ على مفعول رجعي يمتدّ لعشر سنوات سابقة على تاريخ صدور القانون، وذلك في ما يتعلّق بملفّات تخصّ إعادة هيكلة القطاع المصرفي، غير أنّ الإبهام لا يزال يلفّ مدى انطباق هذا الأثر الرجعيّ على التحقيقات القضائية، وحصره بالإجراءات الرقابية فقط.
– ثانياً: الفقرتان “هـ” و”و” من قانون السرّية المصرفية.. رفع مشروط للغلالة
التعديلات التي طالت الفقرتين “هـ” و”و” أتاحت للجهات الرقابية إمكانية طلب معلومات من دون الحاجة إلى تحديد مسبق لهويّة صاحب الحساب. ونصّت، بدورها، على مفعول رجعي لمدّة عشر سنوات. لكن يبقى السؤال معلّقاً: هل تشمل هذه الصلاحيّات كلّ أنواع التحقيقات، أم تُحصر بالرقابة المؤسّسية فقط؟ وهل يمكن الاستناد إليها في ملاحقات جنائية أم تفتقر إلى الغطاء القانوني الواضح لذلك؟
تفاوت خطير
– ثالثاً: غموض المفعول الرجعيّ.. نقطة الضعف القانونيّة وساحة المراوغة المصرفيّة
الإشكاليّة الأهمّ في التعديلات الأخيرة على قانون السرّية المصرفية وقانون النقد والتسليف تكمن في الصياغة المبهمة التي تناولت مبدأ المفعول الرجعي. فبينما ينصّ الدستور اللبناني، كما معظم النظم القانونية المقارنة، على أنّ القوانين لا تُطبّق بأثر رجعي، خصوصاً في الشق الجزائي، إلّا بنصّ واضح وصريح، جاءت التعديلات الأخيرة غامضة وغير حاسمة في هذا الشأن.
نعم، أُشير إلى “مفعول رجعي يمتدّ لعشر سنوات”، لكن من دون توضيح ما إذا كان هذا الامتداد الزمني يشمل الملفّات القضائية ذات الطابع الجنائي أو شبه الجنائي، أم يُحصَر في إطار الإجراءات الرقابية والإدارية فقط. هذه المسافة الفاصلة بين ما يُفترض بالقانون أن يُجيزه وما يجرؤ القضاء أو الجهات الرقابية على طلبه، فتحت الباب واسعاً أمام تفسيرات متباينة وتأويلات متناقضة.
هنا بيت القصيد: ما الذي يمكن أن نتوقّعه من المصارف؟ في غياب التفسير الرسمي الحاسم، سواء من المجلس الدستوري أو الهيئة العامّة لمحكمة التمييز، سنكون أمام طيف واسع من ردود الفعل المصرفية:
- مصارف ستعتمد نهج الإفصاح الشامل والتحوّط القانوني، بدافع الخوف من الملاحقة لاحقاً، أو لتحسين صورتها أمام الجهات الدولية.
- مصارف أخرى، خصوصاً تلك المتورّطة في شبهات أو التي تؤوي حسابات سياسية حسّاسة، ستتمسّك بتفسيرات ضيّقة وتتحصّن وراء النصوص المبهمة لتفادي الانكشاف أو تسهيل التحقيقات.
وهذا ما يُنذر بتفاوت خطير في التطبيق بين مصرف وآخر ويُقوّض مبدأ المساواة ويجعل العدالة انتقائية. فبدلاً من أن يُشكّل القانون أداة توحيد وضبط، يتحوّل إلى مساحة رمادية يُوظّفها كلّ طرف بما يناسب مصالحه أو يجنّبه المساءلة.
الأسوأ أنّ هذا الغموض قد يُستخدم من قبل بعض المصرفيين ذريعةً للمماطلة أو المراوغة. فقد يطالب المصرف بالتدقيق في قانونية كلّ طلب، أو يُحيل الملفّ إلى لجنته القانونية، أو يُصرّ على صدور حكم قضائي نهائي قبل الإفصاح. وفي بيئة سياسية متأرجحة ومؤسّسات قضائية بطيئة أو مُخترَقة، قد يتحوّل هذا التمنّع إلى نمط عامّ يُفرغ النصّ من مضمونه ويعيد إنتاج التعطيل باسم الإجراءات.
هنا تكمن الحاجة إلى موقف تشريعي أو قضائي حاسم: لا يكفي أن يقال إنّ القانون “ينصّ على مفعول رجعي”، بل يجب تحديد طبيعة المعلومات التي تُكشف؟ ولمصلحة من؟ وتحت أيّ ظرف؟ وبأيّ ضمانات؟ فالمصرفي، في نهاية المطاف، ليس مشرّعاً ولا قاضياً، لكنّه غالباً ما يتصرّف باعتباره كليهما في ظلّ غياب السلطة الواضحة. المطلوب ليس فقط تعديل النصّ، بل حسم التفسير، وإلّا فسنبقى في دوّامة مألوفة: قوانين تُسنّ، لا لتُطبّق، بل لتُراكَم فوق غيرها، وتُستعمل أحياناً سلاحاً في نزاعات سياسية، أو واجهةً في معارك دولية حول الشفافية، من دون أن تغيّر فعليّاً سلوك النظام المالي أو بنيته المتحجّرة.
– رابعاً: التّعديلات المقترحة الأخرى.. إصلاح انتقائيّ؟
تشمل الحزمة الإصلاحية المقترحة تعديلات إضافية لا تقلّ أهمّية، أبرزها:
- إلغاء السرّية المصرفية أمام القضاء، بما يتيح للسلطات القضائية الوصول إلى المعلومات دون تعقيدات إدارية.
- منح هيئة التحقيق الخاصّة صلاحيّة التحرّك تلقائيّاً دون انتظار إحالة.
- تعديل قانون العقوبات لربط رفع السرّية المصرفية بمخالفات مثل الإثراء غير المشروع والمضاربة على العملة.
- تعزيز صلاحيّات لجنة الرقابة على المصارف لفرض عقوبات تأديبية مستقلّة عن السلطة القضائية.
لكن على الرغم من هذا التوسّع الظاهريّ، يبقى واقع التطبيق رهناً بنوايا المؤسّسات المعنيّة وقدرتها على تفعيل هذه النصوص.
– خامساً: ما وراء النصوص.. الحاجة إلى إصلاح بنيويّ أعمق
لا يمكن فصل هذه التعديلات عن السياق الدولي، فالمصارف اللبنانية تخضع لقوانين مثل:
- قانون الامتثال الضريبي الأميركي (FATCA).
- الاتّفاق المتعدّد الأطراف للتبادل التلقائيّ للمعلومات (CRS).
- القانون رقم 2015/44 المتعلّق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
مع إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل الماليّ (FATF)، أصبحت المحافظة على قانون السرّية المصرفية، حتّى بصيغته المعدّلة، أشبه بجريمة اقتصادية. السرّية لم تعد وسيلة لحماية الحقوق بل أداة لحماية الفساد.
عقد ماليّ جديد؟
خلال السنوات التي سبقت الانهيار الماليّ، تحوّلت أموال المودعين إلى “عاهرة الاقتصاد اللبناني” التي يتهافت الجميع على نهشها دون حسيب أو رقيب. السياسيّ استعملها لتمويل شعبيّته، والمصرف استثمرها في سندات الفساد، والمصرفيّ استفاد من الفوائد المزدوجة، والمركزيّ أدارها بمنطق “الهندسات البهلوانيّة”، فيما بقي المودع الحلقة الأضعف في معادلة جشع منظّمة تتخفّى وراء قانون السرّية المصرفية.
لم يعد اليوم جائزاً أن تبقى المصارف بؤرة شكّ أو أن يُنظر إليها كأداة لطمس الحقيقة. المطلوب هو استعادة الثقة عبر إعادة تعريف دور المصرف: من متواطئ إلى شريك، من محصَّن إلى خاضع للمحاسبة، ومن صندوق مغلق إلى رافعة للنموّ والاستثمار.
لتحقيق ذلك، لا يكفي تعديل قانون السرّية المصرفية، بل ينبغي إلغاؤه بالكامل، مقابل تحصين حقيقي لمفهوم السرّية المهنية التي تحمي الخصوصية الشخصية لا الفساد المؤسّسي. لكنّ هذا التحصين لا يجوز أن يتحوّل إلى قناع جديد للممانعة. ففي غياب أسباب موجبة ووثائق تبرّر طلب المعلومات، سيكون من السهل على المصرفي أن يتحصّن خلف السرّية المهنية لرفض الإفصاح، أو المماطلة في التنفيذ، أو التذرّع بصياغات غير واضحة لتفادي التعاون. وهنا تكمن خطورة الإبقاء على النصوص فضفاضة أو غامضة: فهي لا تمنح فقط مساحة للتهرّب، بل تعطي المصرفيّين غطاءً قانونيّاً لعرقلة التحقيقات وإخفاء المعلومات وتبرير التقاعس.
لا يبدأ الإصلاح الحقيقي بتعديل القوانين، بل بتجفيف منابع المراوغة داخل النصوص نفسها، وبترسيخ ثقافة التطبيق لا التجميل. ولا يمكن لثقة أن تُبنى من جديد في ظلّ تفسير انتقائيّ أو تطبيق مزاجيّ للقانون. فالشجاعة التشريعية يجب أن تُقابلها إرادة تنفيذية لا تخضع للمساومة، وقضاء مُحصَّن لا يُهادن، ورقابة تُمارَس بما هي حقّ لا ترف إداريّ.
لا يحتاج لبنان إلى نظام مصرفيّ جديد فقط، بل إلى عقد ماليّ واجتماعي جديد يعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمودع، وبين المصرف والمواطن، على أساس الثقة لا التواطؤ، والشفافية لا التستّر، والمساءلة لا الحصانة.
محمد فحيلي -اساس
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|